في مفارقة تكاد تختزل المأساة الفلسطينية بكل مستوياتها، نشهد كيف "ينجح" 59 أسيراً من جنود جيش الاحتلال في تحريك الشارع السياسي والإعلامي، داخلياً وخارجياً، بينما يُقابل استشهاد أكثر من 59 ألف فلسطيني بصمت وتبلّد، محلياً، وفي الوطن العربي "الكبير" عموماً.
لماذا تهتز دولة لأسير واحد، ولا تنفجر أمة لـ "سلسلة" غير منتهية من المجازر المروعة وشلال من الدم لا يتوقف؟ الجواب لا يكمن فقط في المعايير "الأخلاقية" المزدوجة للعالم، بل أيضا في الفجوة بين ثقافتين، أحدهما تصنع من الفرد "قضية"، تحملها الى سمع الدنيا وبصرها، حتى لو كانت صناعة رديئة، لكنها تجد من يشتريها، أو يجبر على شرائها، وأخرى تستبطن الألم وتكتفي بالصبر السلبي، الذي هو رديف العجز، أو الحداد الصامت المجرد من الغضب، دون أن تحول هذا الألم إلى فعل جماهيري، أو حتى سياسي وإعلامي ضاغط.
هل هو صراع بين القيمة الرمزية والتراكم العددي؟ هناك، كل أسير هو "قضية دولة"، يقدم كـ"رمز قومي"، وتبنى حوله حملات ضغط، وتنظم المظاهرات، وتجند المؤسسات -الإعلامية والعسكرية والأكاديمية وغيرها- وتلتف العائلات والأحزاب "المعارضة" حول قضيته، يقدم كابن لكل بيت، ورمز يجب استعادته، وقبل ذلك استعادة صورته، مهما كلف "الثمن"، وحتى لو كان عشرات آلاف الأرواح من النساء والأطفال، لقد جعلوا من كل أسير مشروع حملة ضغط، ومن كل جندي، قتيلاً كان أو أسيراً، أداة لإعادة تشكيل "الرأي العام"، وكأنه هو الدولة ذاتها، أو على الأقل، ذاكرتها ومستقبلها.
في المقابل، يختصر الشهيد غالباً إلى "رقم" في بيان، "تمسح" هويته تدريجياً بعد أيام قليلة، وكأننا فقدنا القدرة على منح الشهداء وزنهم الرمزي، وحضورهم النابض بالحياة في وعينا الجمعي، لم تعد صور الشهداء ولا مشاهد الإبادة والقتل تحدث نفس الرجّة، وكأننا اعتدنا على الموت، موت يعيشه بعضنا، ولكننا نحياه جميعاً.
أصبحنا نعد شهداءنا بالجملة، ألف فألفان، فعشرة فخمسون، وعدّاد الشهداء لا يتوقف، يدفن الشهداء -إن أمكن ذلك- ثم تمضي الجموع بصمت، وكثير من العجز، دون أن تتحول الدماء إلى فعل سياسي ضاغط، أو إلى موقف جامع، على الأقل لدى "النخبة" السياسية، التي يعيش بعض افرادها ويتنعمون وكأنهم من كوكب آخر، فمشهد الموت لم يغير من روتينهم اليومي شيئاً، لا زالوا يفيقون كما اعتادوا، من دفء فراشهم الوثير، إلى حمامهم الدافئ، بقدر دفء دم الشهداء حين تدفق أول مرة، لا يتنازلون عن قهوة الصباح، لكنهم يمكن أن يتنازلوا عنا جميعاً، عنا نحن الوطن، بعضه أو جله.
لقد فقدنا القدرة على تحويل الشهادة إلى قضية، والشهداء إلى رموز -إلا ما ندر- أو على الأقل إلى مطالب لإحقاق الحق وإقامة العدل، فما عاد الدم يلهب المشاعر، ولا يحرك الساحات، لا لأننا لم نعد نحزن - فالحزن بات قوتنا اليومي - بل لأن الثقة بالرواية، كما القيادة، كما القدرة على التأثير، قد تآكلت بشكل خطير، فأصبحت لدينا أزمة في التعبئة، لا في المشاعر، وبات الفرق ليس في مقدار الحزن، بل في آليات التعبير عنه، جنازاتهم تقمع، وتاريخهم يمحى، وصورهم تشوّه، حتى بتنا نعاني من تشظ خطير في السردية الوطنية، وانقسام طولي وعرضي، جعل من بعضنا مقبرة لصوت بعضنا الآخر.
منذ متى كانت التضحيات الكبرى في فلسطين مجرد أرقام؟ منذ متى تحول الشهداء إلى إحصاءات؟ من يجرؤ أن ينزع عن الشهيد معناه؟ من حوّل تضحياتنا إلى مجرد كلمات تمر على شريط الأخبار الأحمر بلون الدم؟ حتى بتنا لا نطالب بما لنا، ولا نصر عليه، بل نتراجع لنبكي ما خسرنا، نعم نرثي، لكننا لا نضغط، نعم ننوح، لكننا لا نتقدم، فثقافة الحق تراجعت أمام ثقافة الفقد، وكأننا أمة اكتفت بالتأبين، تأبين بلا استراتيجية، فهناك كل فرد يملك دولة تصرخ لأجله، وهنا، الوطن يئن، ولكن صوته لا يكاد يسمع.
.........
منذ متى كانت التضحيات الكبرى في فلسطين مجرد أرقام؟ منذ متى تحول الشهداء إلى إحصاءات؟ من يجرؤ أن ينزع عن الشهيد معناه؟ من حوّل تضحياتنا إلى مجرد كلمات تمر على شريط الأخبار الأحمر بلون الدم؟











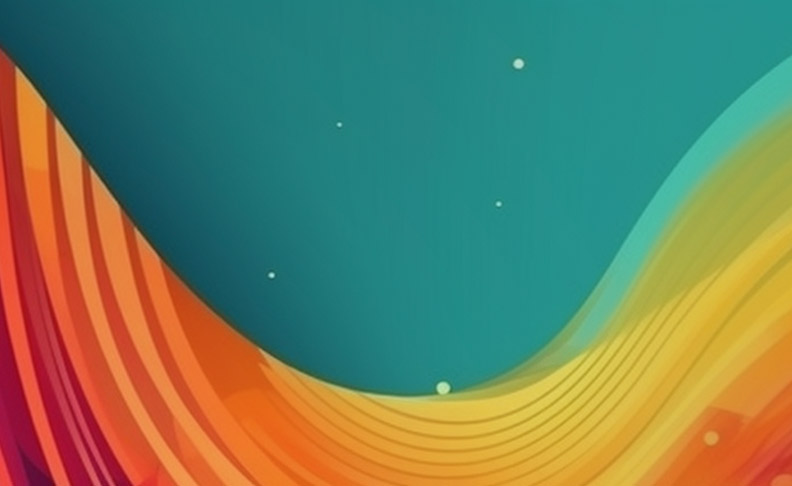
شارك برأيك
59 ألف شهيد.. و59 أسير: حين يئن الوطن وتصرخ دولة