ليس الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مسألة عابرة، بل هي تأسيسية لمستقبل يشي باندثار المشروع الوطني الفلسطيني، وخصوصاً مع تفلّت الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أي قيود، وذلك ما لم يتدارك الفلسطينيون الأمر ويباشروا في إجراء مراجعة نقدية شاملة للتعلم من الأخطاء، وإعادة بناء هذا النظام على أسس جديدة يكون هدفها الأساسي تكريس مصادره وإمكاناته كلها لضمان تثبيت الفلسطينيين في بلدهم.
تعلمنا التجارب التاريخية أن أهم ما ينتج من الحروب لا يكمن فيما يحدث خلالها من اقتراف للمذابح والأهوال، فهذه أمور، مع عظم فداحتها، سرعان ما يجري تخطّيها بعد أن تضع الحروب أوزارها، ويتحول الانشغال إلى معالجة تداعياتها، والتعايش مع ذكرياتها. إن أهم نواتج الحروب يتأتى دائماً عمّا تفضي إليه من تحريك لميزان القوى بين الأطراف المتحاربة، وهو ما يتيح للأطراف المنتصرة فرض التسويات التي تحقق أهدافها على الأطراف الخاسرة. وتنبئونا دراسة تاريخ الحروب أن هذه التسويات هي المهمة، لأنها في كل مرة تؤدي إلى تشكيل واقع جديد لا يقتصر فقط على إمكان تغيير الخرائط السياسية، بتعديل حدود دول وإلغاء وجود أُخرى بالكامل، أو تحريك مجموعات من الناس من مناطق إلى أُخرى، ينجم عنه تغيير الطبيعة الديموغرافية لدول متعددة، بل إن الحروب تقود إلى إحداث تحولات جوهرية في التوجهات السياسية، وتطيح بطموحات وطنية لكثير من الشعوب والجماعات القومية.
طوال فترة الخمسة عشر شهراً الماضية، انصبّ اهتمام مختلف الأطراف على متابعة مجريات الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة. وكانت المتابعات حثيثة، نظراً إلى حدة هول هذه الحرب، واتساع نطاقها، وشمولية استهدافها، وشدة ارتفاع عدد ضحاياها المدنيين، وضخامة ما ألحقته من تدمير طال جميع مقومات الحياة في تلك الرقعة المحدودة التي تقصدت إسرائيل إلحاق نكبة كبرى بها. فهدف إسرائيل من هذه الحرب لم يكن الانتقام لعملية "طوفان الأقصى" فقط، بل تحقيق مقصد استراتيجي أبعد من ذلك كثيراً، وحاضر دائماً في الأيديولوجيا الصهيونية، وهو تفريغ الأرض من أهلها الفلسطينيين. لقد لاحت لها فرصة كانت تتوق إليها دائماً، فقامت بتحويل انتقامها إلى حرب إبادة وظّفت خلالها تحالفاتها الخارجية كلها، وقدراتها التدميرية، لتحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للمعيشة البشرية، من أجل دفع أكبر عدد من الفلسطينيين إلى المغادرة وإخلاء المكان.
بُعيد شنّ الحرب بقليل، فُتحت في عواصم إقليمية وغربية مداولات تتعلق بـ "اليوم التالي"، أي بترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، اختُزل معظم اهتمامها على إيجاد البديل المقبول لحكم القطاع بعد القضاء على حركة "حماس"، والذي اعتُبر أمراً مفروغاً منه، وعلى سعي الحكومة الإسرائيلية لإطالة أمد الحرب والوجود في غزة، ومطالبات السلطة الفلسطينية باستعادة زمام السيطرة على القطاع، والدعوات التي جاءت من هنا وهناك إلى ضرورة وجود إقليمي ودولي ولو لمرحلة انتقالية، وسعي حركة "حماس" لئلّا تُستثنى من الاعتبار. وإلى جانب ذلك لم تتم معالجة جذر الصراع الكامن في استمرار الاحتلال، وضرورة إيجاد تسوية نهائية ودائمة له، وهو أمر لم يُعطَ ما يستحق من الجدّية الفعلية. ولولا اشتراط المملكة العربية السعودية بأن يتلازم تطبيع علاقاتها بإسرائيل، مع مسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية، وصدح آخرين بكليشيهات مناشدات ومطالبات بضرورة إقامة هذه الدولة، لغاب موضوع ضرورة المعالجة الجذرية للصراع عن الأجندة بالكامل. لقد استأثرت مجريات الحرب ومستقبل الحكم في غزة بالمشهد.
أمّا وقد جرى التوصل إلى "صفقة" لوقف موقت للنار، فإنه يؤمل إن تم الالتزام بتنفيذ مراحلها الثلاث، أن تؤدي إلى وضع نهاية للقتال. لكن كي تضع الحرب أوزارها نهائياً، يجدر مراقبة ليس فقط الكيفية التي سيتم بموجبها "ترتيب" الوضع المستقبلي في قطاع غزة، مع أهمية ذلك، بل ما ستُفضي إليه الحرب من تسوية مرتقبة للصراع أيضاً، فالحروب، وليس القتال، لا تنتهي إلّا عندما تُعقد التسويات.
المواجهة الصعبة
يواجه الفلسطينيون حالياً واقعاً غاية في التعقيد والصعوبة، الأمر الذي يفرض عليهم تحدياً استثنائياً يفوق بأهميته ما خبروه في السابق من تحديات. فمع أن ما واجهه الفلسطينيون خلال تاريخ مقارعتهم الطويلة لانتداب بريطاني واحتلال إسرائيلي كولونيالي إحلالي، كان جسيم التكلفة، إلّا إنهم حظوا في كل محطة مواجهة بركيزة، أو ركائز، إسناد فاعلة، أعانتهم على الصمود والمقاومة، وإبقاء جذوة قضيتهم الوطنية حية. أمّا الآن، فقد تكالبت عليهم، وهم في حالة وهن شديد، مجموعة من العوامل الخارجية السلبية التي تشي بفقدانهم لأي مصدر إسناد خارجي فاعل، وانكشافهم أمام تحدي إمكان فرض تسوية "حدّ أدنى" عليهم، تؤدي إلى تصفية قضيتهم.
على الصعيد الإسرائيلي، يواجه الفلسطينيون الآن إسرائيل مختلفة تماماً عمّا خبروه في السابق. فهي لم تعد ذات توجهات يسارية، أو حتى يمينية ليبرالية، بعد أن تمكّن أقصى اليمين من أتباع الصهيونية الدينية ذات العقيدة التوراتية المتمحورة حول ضرورة تحقيق نبوءة "إسرائيل الكبرى"، من التغلغل المتدرج داخل نسيجها السياسي، إلى أن وصل في سنة 2022 إلى المشاركة في الائتلاف الحاكم، والسيطرة على إمكان استمراريته. لقد عبّر هذا التحوّل عن انزياح مستمر لتوجهات الإسرائيليين السياسية نحو اليمين، وأدى إلى انكماش متواصل لقاعدة اليسار الانتخابية التي أصبحت تلامس درجة التلاشي. فالثقل السياسي في إسرائيل لم يعد يمينياً فحسب، بل باتت تتأصل فيه النزعة المتزمتة، والمتطرفة، والمستشرسة تجاه الفلسطينيين.
ضمن هذا التحول في المشهد السياسي في إسرائيل، لم يعد لتسوية توافقية مع الشعب الفلسطيني تفضي إلى "حل الدولتين"، بالمفهوم التقليدي لهذا الحل الذي ينادي بإقامة دولة فلسطينية على الأرض المحتلة منذ سنة 1967، أي إمكان فعلي للتحقق. فبالنسبة إلى القدس، يوجد إجماع إسرائيلي على عدم التخلي عنها. أمّا الضفة التي أثخنتها العملية الاستيطانية تقطيعاً، وحوّلت الوجود الفلسطيني فيها إلى معازل ضيقة ومنفصلة عن بعضها، فإن أغلبية إسرائيلية مطلقة تطالب بضمّ أجزاء واسعة منها لإسرائيل، بينما تستميت الأطراف اليمينية المتطرفة، وباستخدام جميع الوسائل السياسية والخشنة، في مسعى تنفيذ ما تعتبره مهمة توراتية – عقائدية لحسم أمر ضمها بالكامل، وبأقصى سرعة ممكنة. أمّا قطاع غزة الذي تخلّى أريئيل شارون عنه، وبقيت إسرائيل تحاصره، فكان هو الرقعة الجغرافية الوحيدة التي كان هناك إمكان لسماح إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية فيه، كون اهتمامها بشأنه يتركّز في ضمان الناحية الأمنية التي إن تم الاتفاق على إجراءات كفيلة بتحققها، يصبح من الممكن لإسرائيل التخلص منه، وممّا يمثله من عبء ديموغرافي عليها. غير أن سيطرة حركة "حماس" على القطاع منذ سنة 2007، ثم قيامها بعملية "طوفان الأقصى" مؤخراً، قلّص هذا الإمكان إلى الحد الأدنى، مع أنه لم يُلغِه بالكامل.
وعلى الصعيد الإقليمي، يجدر الأخذ في الاعتبار أن وضعية الحاضنة التقليدية التي كانت تتمتع بها القضية الفلسطينية سابقاً في الأوساط الرسمية العربية، تراجعت حالياً. فالصراعات المتلاحقة التي مُني بها العالم العربي، أدت ليس فقط إلى انكفاء الدولة القطرية على ذاتها، سعياً للمحافظة على الوجود وتحقيق المصالح الخاصة، بل أيضاً إلى شرذمة التضامن العربي الجماعي، وفقدان المنظومة العربية مكانتها وقدرتها التأثيرية في الإقليم لمصلحة القوى غير العربية: إيران وتركيا وإسرائيل. يضاف إلى ذلك تصاعد وتيرة التذمرات من العديد من العواصم العربية من استمرار وطأة الملف الفلسطيني عليها، ومتاهات الانقسام الفلسطيني، وتحالف أطراف فلسطينية مع قوى إقليمية غير عربية، وتحديداً مع إيران. ونتيجة ذلك، أصبح تعامل الأوساط الرسمية في معظم الدول العربية مع الملف الفلسطيني يندرج في أفضل الأحوال تحت باب درء المخاطر، وذلك من خلال ازدواجية تقديم ما يلزم من دعم معنوي لتجنّب الإحراج أمام مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، لكن مع تجنُّب الانخراط الفعلي في الدفاع الجدّي عن الحق الفلسطيني بصفته قضية قومية عربية.
إلى جانب زعزعة قوة حركة "حماس" السلطوية وإنهاك قدراتها العسكرية، أدت تدخلات إسرائيل في الإقليم في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" إلى تفكيك محور المقاومة الذي كانت الحركة تعوّل عليه في إسناد وجودها ومواجهتها مع إسرائيل. ومع تغير موازين القوى الإقليمية نتيجة ذلك، بات أمر تشكيل وضع جديد بالمنطقة أيسر. ولأن إغلاق ملف القضية الفلسطينية أصبح ضرورياً، من باب إزالة "عائق مزمن" من أمام إعادة هذا التشكيل، فإن أي تسوية تُظهر بأنها تضمن "الحد الأدنى" من حقوق الفلسطينيين، ستفي بغرض العواصم العربية.
أمّا عودة ترامب إلى الرئاسة في أميركا فإنها التغير الأهم على الصعيد الدولي حالياً، وسيكون لها أثر بعيد المدى فيما يتعلق بإعادة تشكيل المنطقة، وإغلاق ملف القضية الفلسطينية بصورة نهائية. وقد استبشرت أطراف فلسطينية وعربية خيراً من التدخل الفاعل لترامب في فرض "صفقة" الوقف الموقت للنار في غزة، على أنها دلالة مبكرة على إمكان حدوث تحول إيجابي في كيفية نظرته وطريقة معالجته للتسوية المرتقبة. لكن على المتفائلين التريث كثيراً، فترامب ذو شخصية نرجسية، وأي تغير يكون قد طرأ عليه وهو يدخل ولايته الثانية، ينحصر في التحرر من أي قيود ربما تكون كبحت جماحه، ولو قليلاً، خلال فترة ولايته الأولى، لتطلّعه إلى ضمان ولاية ثانية. فترامب الآن، وهو في الولاية الأخيرة، سيتصرف على سجيته؛ حاكم مطلق يحكم بالأوامر والإملاءات، من دون كوابح أو الالتفات إلى قواعد، وستكون سياسته الخارجية محكومة بـ "أميركا أولاً"، يمارسها بفجاجة استعراضية بالتهديد والابتزاز، وتوزيع الاتهامات والإهانات، وإعلان المطالب وتوقّع الامتثال، وفرض العقوبات على "العُصاة".
إن ترامب مؤيد مضمون لإسرائيل، وإن لم يكن بالقدر نفسه لنتنياهو وائتلافه الحكومي، ولا يأبه للشعب الفلسطيني ومحنته المستمرة، ولا يكنّ كثيراً من الاعتبار للنظم الرسمية العربية التي يعتبرها تابعة ومضمونة الولاء. ويُستثنى من ذلك تقديره للمملكة العربية السعودية، ليس فقط لكونها مركز ثراء مفيد، بل أيضاً لمكانتها الاعتبارية التي تؤهلها لأداء دور قيادي أساسي وبارز في العالمَين العربي والإسلامي. ولأنه يريد تحييد منطقة الشرق الأوسط عن إشغاله بقضاياها وهو منهمك في متابعة قضاياه المركزية، داخلياً وفي مناطق أُخرى من العالم، فإن هذه المنطقة لن تحظى منه إلّا على اهتمام وجيز سيكرسه لتحقيق استقرارها بشكل سريع، وإزاحتها عن جدول أعماله، ليتفرغ للأهم. وهو يعتقد أن ركيزة هذا الاستقرار تكمن في تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل، والذي سيجّر وراءه تطبيع العديد من الدول العربية والإسلامية معها، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير جوهري في واقع المنطقة. وعدا معالجة موضوع إيران وملفها النووي، فإن إتمام هذا التطبيع يتطلب إغلاق ملف القضية الفلسطينية بتسوية توازن بين المطلب السعودي بوجود مسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية، وتحقيق مصلحة إسرائيل بتوسيع رقعة مساحتها التي صرّح ترامب بأنها غير كافية.
وعلى الرغم من ضآلة محتوى "صفقة القرن" الفلسطيني، فإن ترامب لن يعود إلى طرحها بصيغتها السابقة، إذ من الواضح أنها اضمحلّت بفعل عملية "طوفان الأقصى"، إن لم تكن انتهت تماماً. وإذا ارتأى ضرورة مراعاة المطلب السعودي، فإن أفضل مقاربة يمكن لترامب أن يمليها، ستكون على الأغلب مقلّصة، تأتي على هيئة وعد يمكن أن يتحقق بعد مرور فترة انتقالية طويلة مليئة بإعادة التأهيل واجتياز الاختبارات وتحصيل الالتزامات من الفلسطينيين، وسيحصر فيها إمكان إقامة كيانية فلسطينية تتمتع ببعض المظاهر السيادية للدولة في قطاع غزة، مع احتمال إيجاد علاقة مستقبلية للمعازل الفلسطينية المتبقية في الضفة معها. وفي مقابل ذلك، سيمنح ترامب غطاء لضم إسرائيل جزءاً كبيراً من الضفة إلى سيادتها. وبما أنه يتعامل مع الأطراف الرسمية العربية ذات العلاقة بعقلية الإملاءات، ويتوقع منها الانصياع، فإن تركيز ترامب سينحصر في معظمه على تحصيل موافقة تل أبيب عليها، التي ستتمنّع قبل الموافقة، وستحصل من أجل "إقناعها" على رزمة سخية من "المحفزات"، قد يكون أولها طلب ترامب تفريغ القطاع من أغلبية أهله الفلسطينيين. ومع أن هذا الطلب قد يبدو للبعض كأنه دليل قاطع على إغلاق ترامب نهائياً لـ "حل الدولتين"، إلّا إنه قد يكون المدخل السيىء لفرض تسوية سيئة وفقاً لهذا الحل.
إن كان هناك تسوية تلوح في الأفق بعد أن تنتهي الحرب على غزة، فإن هذه هي الحدود القصوى لملامحها، وكل مَن أضعفت الحرب وضعيته في ميزان القوى، عليه أن يدفع فاتورة التسوية الناجمة عنها.
حالة الوهن الفلسطيني
منذ فترة والوضع الفلسطيني يراكم زيادة مطردة في مدى ما يعانيه جرّاء حالة إعياء متفاقمة، ناتجة من تفشي الوهن الذي استفحل وهو ينخر مختلف بُنى المنظومة الفلسطينية. وقد أدت هذه الحالة إلى التخفيض المستمر للمناعة الفلسطينية، الأمر الذي يقلّص لأدنى مستوى إمكان تمكّن القدرة الذاتية بمفردها، بعد ذويان حاضنة الإسناد الخارجية التقليدية، من مواجهة سيل الضغوط المنهمرة على الجانب الفلسطيني، بصورة فاعلة ومؤثرة. بل على العكس تماماً، إذ قد يؤدي مستوى التردي الذي وصلت إليه حالة الوضع الفلسطيني حالياً، إلى انكشاف أمام هذه الضغوط، وهو ما يمكن أن يسهّل للآخرين تمرير تسوية "الحد الأدنى" للقضية الفلسطينية.
يعاني النظام السياسي، المقيّد أصلاً بقيود الاحتلال، حالة مزمنة أصبحت مستعصية، من التكلُّس الذي أفقده معظم قدرته وفاعليته السياسية. فهذا النظام استقر منذ نحو عقدين من الزمن على انقسام معزز بانفصال جغرافي أحاله إلى حالة دائمة؛ حركة "فتح" تحكم في الضفة، وحركة "حماس" تحكم قطاع غزة. وبسبب حالة العداء المتجذر بين الطرفين، وتوجُس كل طرف من نيات الطرف الآخر، ومعارضة الطرفين أحدهما للآخر فيما يتعلق بوسيلة مواجهة الاحتلال (المقاومة المسلحة في مقابل المسار السلمي)، أحكم كل منهما قبضته على مقاليد الحكم في منطقته، ووسّع تغلغل وسيطرة منظومة هذا الحكم على مواطنيها. ومع ازدياد منسوب سلطوية طرفَي النظام السياسي، تم تغييب عناصر وأدوات الفعل السياسي، فلا أحزاب فاعلة، أو انتخابات، أو سلطة تشريعية، أو قضاء مستقلاً وفاعلاً، أو إعلام حراً، أو وسائل مستقلة للرقابة والمساءلة والمحاسبة. لقد تم وأد الحياة السياسية برمّتها، بعد أن جرى تقليص مساحة المجتمع السياسي بإقصاء العديد من الفئات المجتمعية عنه، الأمر الذي أدى إلى تفشي حالة متسعة من الإحباط العام، وانحسار هذا المجتمع ليشتمل فقط على مؤيدي الطرفين، وشرخه ليهوي في حالة استقطاب وتعصب شديدين، تحول معها النقاش السياسي إلى مجرد سجالات جدالية عقيمة سرعان ما تنزلق إلى مناكفات مليئة بتراشق الاتهامات وتبادل التنديدات التي تصل إلى التخوين. لقد تحولت المشاركة السياسية من فضاء مفتوح للتأثير وإحداث التغيير، إلى مجرد وسيلة لتحشيد مظهري للمبايعة والتأييد، من جهة، والتهميش والإقصاء، من جهة أُخرى.
وبما أن استدامة النظام أصبحت هي الأولوية التي تُشكّل محور وعي وتوجه وتصرُّف مسؤوليه، أكان ذلك في الضفة أم في القطاع، فقد أصبح الخطاب السياسي شعبوياً، مثقلاً بتكرار كليشيهات وشعارات تقليدية تنزلق من أعلى إلى أسفل، بسردية مبرمجة لتضخيم الشعور الذاتي بالأهمية والإنجاز، وإرضاء رغبات جمهور المؤيدين بإسماعهم ما يودون سماعه، وليس ما يجب سماعه، وإعطائهم ذخيرة لمواجهة "الآخرين". لقد استُحكم التمترس وراء المواقف من المشهد السياسي الفلسطيني الداخلي الذي أُغلق على مَن "مع" ومَن "ضد"، بعد أن أُتمّت عملية إغلاق المجال على حدوث أي مناقشات جدية ومراجعات ذات جدوى للأهداف والمسارات السياسية.
لقد بات النظام السياسي عالقاً في أزمة مستعصية زاد في تفاقمها تصاعد حدة الاستهداف الإسرائيلي المستمر لتدميره، وانحسار الدعم المادي الدولي والإقليمي عنه. فجرّاء حرب إسرائيل التدميرية، تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة يحتاج كل شيء فيها إلى إعادة تأهيل وإعمار، الأمر الذي سيكون ضاغطاً ليس فقط على مَن سيديره في قادم الأيام، بل محدد أيضاً لطبيعة تسوية "الحد الأدنى" للقضية الفلسطينية التي يُعدّ لإخراجها أميركياً. أمّا في الضفة، فقد تكالبت الظروف الخارجية على النظام المأزوم أصلاً، فبات يصارع من أجل ضمان استمرار بقائه، بعد أن لم يعد قادراً على الإيفاء بمقدار متزايد من التزاماته الداخلية. وأدت الأزمة المالية المتفاقمة التي يعانيها إلى حدوث انهيارات في مجالات حياتية حيوية، كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والحياة الاقتصادية. ومن الضروري الانتباه إلى أن انهيار مناعة المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، وإن كان بدرجات متفاوتة بين القطاع والضفة، سيكون له ارتدادات عميقة قادمة على مدى قدرة الفلسطينيين على استمرار التحمل والصمود، وعدم السعي للهجرة من البلاد.
ما العمل؟
قد يكون من أهم الاستنتاجات المستخلصة من عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من حرب مدمرة على غزة، أن الصراع سيستمر مديداً، ولن يُحسم بالضربة القاضية، بل بتراكم النقاط التي يقع في صلبها تعزيز بقاء الفلسطينيين على أرضهم، بعد أن ازدادت مخاطر الهجرة من البلد بفعل تدمير إسرائيل الممنهج لسبل الحياة، وخصوصاً في قطاع غزة. إن هدف إبقاء الفلسطينيين في بلدهم بما يتطلبه من تدخلات تُراكم تحسين مختلف أوجه الحياة، هو الهدف الفلسطيني الأهم استراتيجياً في المرحلة المقبلة. فعلى مدى ما ينوف عن نصف قرن من الاحتلال، اتّبعت إسرائيل سياسة منهجية، معززة بمختلف الوسائل القمعية، لمنع التراكمية الفلسطينية، واستبدالها بتراكمية إسرائيلية لإقامة واقع بديل في الأرض المحتلة، حققت من أجله نجاحات لا يمكن تجاهلها. ومن الضروري والمهم الاعتراف بأن هذه النجاحات ساعدها انهماكٌ فلسطيني بصراع داخلي طويل ومرير، استهلك، ولا يزال، جزءاً أساسياً من الطاقة والقدرة الذاتية اللتين كان من المفترض أن تُوجَّها إلى التصدي للمخططات الإسرائيلية. الآن، ومع تكالب وتكاثف الضغوط الخارجية على الفلسطينيين، وتصاعد احتمال نجاحها في العبث بمصيرهم، تكون الحالة الفلسطينية قد وصلت إلى مفترق طرق حاسم: فإمّا الاستمرار في نهج التناحر الحالي نفسه، ونتائجه السلبية بيّنة، وانزلاق طرفَي الصراع الداخلي، كل بطريقته الهادفة إلى تحقيق مصلحة البقاء، إلى التسابق على التساوق مع طروحات تسوية "الحد الأدنى" المرتقبة، لضمان استمرار الوجود على حساب الآخر، وإمّا تغيير المسار، والذهاب في اتجاه ضرورة الاستدراك ومعالجة الوضع الداخلي لاستعادة ما يمكن من المناعة الذاتية قبل فوات الأوان.
ولن يكون الاستدراك مجدياً إلّا إذا واجه الفلسطينيون حقيقة أساسية كثيراً ما تلافوا مواجهتها: لن يُستعاد الحد الأدنى من القدرة على ترميم الأوضاع الداخلية المنهارة، ولا يمكن تقديم تصدٍّ مقبول للضغوط الخارجية المنهمرة، إذا استمر النظام السياسي الفلسطيني في وضعيته الحالية. وإذا كان للاعتبارات الوطنية أن تطفو على المصالح الفصائلية، فإنه لا بدّ من إحداث تغيير جوهري وعميق في طبيعة بُنيته وطرائق عمله، يتخطى سوابق التعديلات التي قام بها بصورة سطحية وشكلية، وكان الهدف منها أساساً تغليف استمرارية بقائه على حالها.
من الضروري أن يأتي التغيير بتدخلّين متداخلين ومترابطين، أحدهما فوري ومُركَّز ينصبّ على إيقاف النزيف، والثاني أكثر شمولية وأبعد مدى، يستهدف معالجة جذرية للداء، وإعادة التأهيل. ويتطلب تحقيق التدخل الفوري إعادة العمل بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني غير فصائلية، تقطع الطريق على التدخلات الخارجية بشأن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب على غزة، وتُنهي الانقسام، وتستعيد الوحدة الجغرافية لولاية النظام السياسي على الضفة والقطاع. وهذه الحكومة التي يجب أن يُبادَر إلى تشكيلها وتحديد قوامها فلسطينياً هي ضرورة قصوى لدرء مخاطر التدخلات التي تواجه الحال الفلسطينية الآن، ومتطلب أساسي لحشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم، من أجل مواجهة متطلبات وحاجات المرحلة الصعبة المقبلة، وفي مقدمها سحب الذرائع المستخدمة لتعطيل الشروع السريع في عملية إعادة إعمار القطاع، والتصدي العملي لدعوات تهجير أغلبية سكانه.
ومع أن من الأفضل المبادرة فلسطينياً إلى تشكيل هذه الحكومة وتمكينها، عوضاً عن التلكؤ ثم الرضوخ للضغوط الخارجية بشأنها، الأمر الذي يزيد في إضعاف المناعة والقدرة الفلسطينية، إلّا إن إنجاز هذا الأمر، إن تم، يجب ألّا يعني نهاية مطاف إصلاح الوضع الفلسطيني، بل مجرد بدايته. فتعزيز بقاء الفلسطينيين على أرضهم أصبح يتطلب أكثر من مجرد تشكيل حكومة وفق أسس جديدة، مع أهمية وضرورية ذلك، ليصل إلى ضرورة إجراء مراجعة جدّية تخترق احتكار الفصائل للمجال السياسي، للتوصل إلى اتفاق فلسطيني عام، لا يتعلق فقط بمتطلبات تحسين أداء النظام السياسي، بل بجدوى وجوده أيضاً. فقد بات جليّاً أنه لم يعد مجدياً الاستمرار في أخذ كثير من التمنيات الافتراضية كأنها حقائق ثابتة يُبنى عليها فائض من التوقعات المبالِغة، وآن أوان التوقف عن تضليل الذات، والقيام بعملية مصارحة ذاتية فلسطينية عميقة، من أجل إيضاح حدود الهدف المقبول، وليس المأمول تحقيقه، وبناء البرنامج السياسي الملائم لمتابعته.
للإيضاح، ينقسم الفلسطينيون باستقطاب حاد بشأن وسيلة تحقيق هدف تسوية الصراع، فهم باتوا مؤخراً متفقين على أن هذا الهدف هو تطبيق "حل الدولتين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادية على حدود سنة 1967، مع أنهم يدركون انتهاء إمكان تحقق هذا الهدف، لأن "حل الدولتين" لم يعد يعني تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين، وإنما تقسيم الضفة إلى قسمين. ومع ذلك، هل هذا الحل ما زال مقبولاً، ويُسعى له بإصرار مستدام؟ إن كان الجواب نعم، فإنه يتعين على قيادات هذا النظام عدم الاستمرار في المراوغة على الشعب، بل مواجهته بالحقيقة، والقبول بأن التسوية الممكنة ستكون على "الحد الأدنى"، وتكريس الجهد لتحسين شروطها، وتقليص الجزء الذي سيُقتطع إسرائيلياً من الضفة. وإن لم تكن هذه النتيجة المتوقعة من "حل الدولتين" مقبولة، فيجب الوقوف ضد هذا الخيار، والذهاب في اتجاه آخر يسعى لإقامة دولة واحدة، وهو أمر لا يتطلب استمرار وجود سلطة فلسطينية يعوق وجودها إمكان تحقُق هذا المسار.
أمّا إن كان استمرار التمسك بـ "حل الدولتين"، مع معرفة أنه لن يؤدي إلى النتيجة التي يستمر الترويج لها بالشعارات، بل إلى شكل مقلّص عنها في أفضل الأحوال، هو مجرد ملاذ لضمان استمرار النظام، علّ متغيراً إقليمياً أو دولياً يحدث، ويعدّل كفة الميزان، فإن استمرار النظام مثلما هو، حتى في هذه الحالة، لم يعد مجدياً. فهو غير قادر على تحقيق إقامة الدولة الموعودة، أو الإيفاء بالالتزامات الأساسية الضرورية لتمكين استمرار صمود الناس في البلد. لذلك، إن كان لا بدّ من بقاء النظام، فإن نسخته الحالية لم تعد مفيدة إلّا لاستمرار تحقيق المصالح الفصائلية، وهو ما يستلزم إجراء مراجعة نقدية شاملة للتعلم من الأخطاء، وإعادة بناء هذا النظام على أسس جديدة يكون هدفها الأساسي تكريس مصادره وإمكاناته كلها لضمان تثبيت الفلسطينيين في بلدهم، وهذا أمر لن يتحقق إذا ما بقي النظام محتكَراً لاستقطابية فصائلية كانت السبب في استدامة تكلّسه وإنقاص مناعته.
وكي يبدأ النظام السياسي الفلسطيني مسيرة استعادة عافيته، فإن عليه أن يصبح فاعلاً وأكثر مشاركة وتمثيلاً، وعلى علاقة عضوية وإيجابية مع المجتمع، وليس فوقية وسلطوية تسلب من أغلبية الفلسطينيين طاقتهم الإيجابية اللازمة للمساهمة في حماية المشروع الوطني. وعلى هذا النظام أن يتحول من التركيز على المماحكات الداخلية التي تُنفّر أطرافاً خارجية ضرورية لدعم القضية الفلسطينية، إلى السعي الجدي للعودة إلى مسار مراكمة الأصدقاء، إقليمياً ودولياً. وهذا الأمر يتطلب وضوحاً في البرنامج السياسي، وصدقية في التعامل السياسي، وشفافية قصوى في تدبير الشؤون المالية، ومحاربة لا تلين لبواطن الفساد ومواطن الترهل الإداري، وتكريس الجهد لإيقاف انهيار مناحٍ وقطاعاتٍ أساسية لحياة المجتمع، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
غير أن هذا النظام لن يقوم بتغيير ذاته بذاته، لأن ذلك يضرّ بمصالح فئات متحكمة فيه، ومستفيدة منه، ولهذا فإنه يحتاج إلى تحويل التذمُّر الهامس المنتشر داخل المجتمع من إخفاقات أدائه، إلى ضغط منظّم يطالب بالتغيير. ومع أن حدوث هذا التحول صعب، نظراً إلى انغلاق أدوات الفعل السياسي، وموت الحياة السياسية في البلاد، إلّا إن انبعاث الحراك السياسي الضاغط ليس مستحيلاً، بل أصبح ضرورة تفرضها جسامة ما يُحدق بالفلسطينيين وقضيتهم من مخاطر ضخمة. وإذا كان هدف الضغوط الخارجية التي تمارَس حالياً على قطبَي النظام السياسي الفلسطيني هو إضعاف هذا النظام ودفعه إلى تقديم التنازلات، فإن هدف الضغوط الداخلية هو تقويته لمواجهة تلك الضغوط ومقاومة المطلوب منه من تنازلات.
علي الجرباوي: أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة بير زيت.












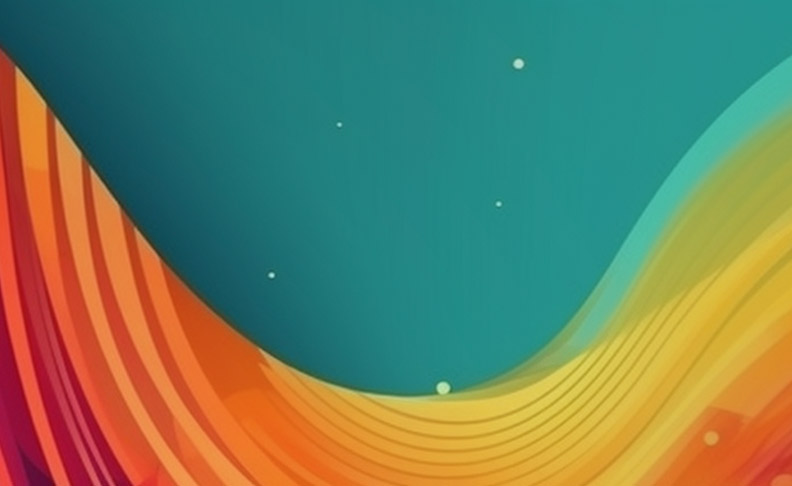
شارك برأيك
الفلسطينيون أمام مفترق طرق